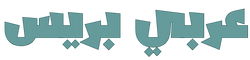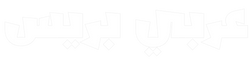أميركا التي لم يُخلق مثلها في البلاد | سياسة

[ad_1]
“يا إلهي كم لبثنا؟!”، شهق وهو ينظر في قائمة الأسعار. كنت اعتدت هذا الردّ ممن كان آخر عهده بتركيا شهرين من الزمن، فما بالك بمن غاب عنها خمس سنوات.
“لقد تراجعت قيمة العملة، وزاد التضخم، وبما أن تخصصك الاقتصاد، فأنت تعلم أنها كلها مصطلحات فنية لإخفاء الحقائق السياسية التي نعيشها”، قلتُ له.
سأل باستهجان: “وما هي هذه الحقائق؟”.
كان صديقي يعرف إلى أي نقطة أريد الذهاب بالحوار، لكنه -بطبيعة الحال- لم يكن متفقا معي.
قلت له: “من يملك حق طبع الدولار يستطيع سرقة مدخرات العالم كله. أعرف أن ثمة نقاشًا كبيرًا حول السياسات الاقتصادية الداخلية لكل بلد يعاني من أزمات اقتصادية، لكن وسط احتشاد المصطلحات الفنية تضيع الحقائق الصلبة. يا صاحبي، هناك من يسرقنا ليمول إنفاقه الهائل على تكاليف البقاء في القمة”.
“هذا منطق السوق المفتوح، عليك أن تتحمل خسائره مثل ابتهاجك بمنافعه“، قال لي بشكل مقتضب مصحوب بالتذمّر.
ربما يكون غوته هو الذي قال: “لا يكون المرء في البداية، ضد شيء، أشد مما هو ضد أغلاط تخلّى عنها”، لكن الأكيد أن صديقنا هذا، الذي سيبدو لكم من أشد المدافعين عن النموذج الأميركي لرؤية العالم، كان يساريا قبل أن يسافر إلى أميركا منذ خمس عشرة سنة.
هذه هي أميركا. قادرة على صدم الناس بعد زيارتها، فلا يعودون كما كانوا قبل دخولها؛ إما أن يعودوا على طريقة “أميركا التي رأيت” فيتحمسون لكل ما هو ضدها، وإما أن تقنعهم بنفسها فينفرون من كل ما هو ضدها. وصديقنا -كما هو بادٍ لكم- كان من الصنف الثاني.
لم يكن الموضوع الاقتصادي هو الذي يشغلني، مع معرفتي التامة أنه لا يمكن فهم كلمة واحدة من الاقتصاد دون وضعها في إطارها السياسي العام، ومن ينسون هذه الحقيقة البدهية ينتهي بهم الأمر كموظفي تسويق بدون رواتب لصالح الرأسمالية!
وعليك أن تتذكر، يا من تطلع على حوارنا هذا، أن الاقتصاد مثل كافة “العلوم الإنسانية”؛ وجهات نظر، وذلك على الرغم من هيبة العلوم البحتة التي تبدو عليها الأرقام.
ستتساءل: لماذا إذن افتتحت النقاش بالبعد الاقتصادي؟ في الحقيقة، كان هدفي التأكد من الذي بقي لدى صديقنا من ماضيه. ومن جملة واحدة، أصبح جليا لي، أن شبح ماركس عنده، قد اختفى تحت تأثير الإنارة الفائقة لـ”المدينة المنيرة على الجبل.”[1]
وسأعلن لك نيّتي منذ البداية. إن حواري مع صديقي، يدور في فلك مسألة “البقاء في القمة”، إنه تساؤل واحد لا غير، لكنه شديد التشعب: هل نشهد نهاية العصر الأميركي فعلًا، أم أننا نشاهد “رغباتنا” في نهاية العصر الأميركي؟

نخب أميركا التي لا يحدها شيء
كان صديقي منشغلا بقراءة قائمة الطعام، أو بالأحرى، بمقارنة الأسعار مع آخر مرة زار فيها تركيا، وكنت أتفحصه من دون أن يشعر. كان شكله يبدو أميركيا بالفعل. وكنت قد سمعت ذات مرة، أن الطعام والأفكار بعد فترة من الزمن، يغيّران شكل الإنسان الخارجي، وهو ما يفسر تشابه شكل الأزواج بعد فترة.
قاطع استرسال أفكاري عن العلاقة بين مظهره وأكله وفكره، وقال لي وهو ما زال محدقا في الأسعار: “سأخبرك نكتة راجت في نهاية القرن التاسع عشر في أميركا: ثلاثة رحالة أميركيين كانوا يشربون نخب بلدهم في حضور مستضيفهم الأجنبي.
قال الأول: هذا النخب لأميركا التي تحدها شمالا كندا، وجنوبا المكسيك، وشرقا المحيط الأطلسي، وغربا المحيط الهادئ. قال الثاني: لا، هذا نخب أميركا التي يحدها من الشمال القطب الشمالي، ومن الجنوب القطب الجنوبي، ومن الشرق شروق الشمس، ومن الغرب غروب الشمس. قال الثالث: أقدم لكم أميركا التي يحدها من الشمال الشفق القطبي الشمالي، ومن الجنوب اعتدال الأيام والفصول، ومن الشرق الفوضى البدائية، ومن الغرب يوم الحساب” ثمّ أخذ بدنه يهتزّ من دون أن يصدر منه صوت ضحك، كأنه يريد أن يعطي انطباعًا بأنها نكتة نخبوية، إن لم تُضحكني فهذا لقصور في فهمي.
وبغض النظر عن أنها لم تكن نكتة مضحكة بالفعل، فإنها معبرة عن ثلاث دفقات من الطموح الأميركي الذي كلما التهم قسطا من الأهداف، صار يحلم بالمزيد منها.
قلت لصديقنا: “في الواقع، هذا قانون طبيعي لكل المشاريع الجادة والحالمة، تبدأ عادة بالخطوة الأولى: حسم الهيمنة على النطاق المحلي؛ وهو الذي تجلى في حالة أميركا في ثلاث مسائل: إبادة السكان الأصليين بالبارود والأمراض، ثم طرد البريطانيين، والحرب الأهلية التي قادها إبراهام لينكولن لتوحيد بلاده لمّا عارض الجنوب الأميركي (المحافظ والزراعي) مشروع إلغاء الرق. كان لينكولن -وفق تعبيره- يريد عاملا لديه أحلام، أما العبد فبلا أحلام، ولذا لا يصلح لتأثيث العالم الجديد. وهذا كان جوهر مشروع الشمال الصناعي، الذي حسم رؤيته بتكلفة نحو نصف مليون أميركي.
ثم لاحقا الخطوة الثانية: حسم الهيمنة على النطاق الإقليمي؛ الذي تجلى بوضوح في قانون “مونرو” عام 1823، حاسما نفوذ أميركا على نصف الكرة الغربي، ومتدخلا بالقوة لمنع أي دولة منافسة من الوجود في إقليمها. ومع أن أوروبا سخرت منه في البداية، فإنه فيما بعد، ومع رئاسة فرانكلين روزفلت للولايات المتحدة، أصبح حقيقة واقعية.
أما الخطوة الثالثة فهي: حسم الهيمنة على النطاق العالمي؛ وذلك حين أخذت الولايات المتحدة بالتنافس على ترتيب عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (1941-1991)”.
حين وصلت إلى هذا الحدّ من الشرح، قاطعني صديقنا: “المحلي، الإقليمي، العالمي.. هذا يعني أن الطريق أمام العرب طويل جدا! لكن دعني أسألك: ألم يكن القرن العشرون قرنا أميركيا أيضا؟ صحيح أن أميركا كانت تخشى الاتحاد السوفيتي، لكنه كان يغذي تفوقها، يغذي سرديتها في قيادة العالم الحر، ولذا بعد انهياره، راحت أميركا من فورها تخترع بديلًا له ليكون نقيضا لها، فكان صدام حسين وأسامة بن لادن جاهزين للعب هذا الدور“.
ثمّ أكملت على فكرته: “نعم، لقد قاتلت أميركا بكل قدراتها في القرن العشرين لحسم النطاق العالمي، وكانت التسعينيات تتويجا لهذا الحسم، وأنت تعرف، أنه بدلا من النمط القديم للإمبراطوريات، القائم على الاستعمار المباشر وبناء المستعمرات المكلفة، أخذت في بناء نظام قائم على المؤسسات والاتفاقيات التي تضمن المحافظة على نفوذها، وهذه كانت لا تقل أهمية عن قواعدها العسكرية التي نشرتها في كل مكان في العالم حتى بلغت 700 قاعدة”.
وزدت على ذلك: “بل إن بعضهما يكمل بعضا، وكأن المؤسسات استمرار للحرب بوسائل أخرى، فالأمم المتحدة ضمنت لأميركا شكل الإجماع على قيادتها للنظام العالمي، أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فكانا من أدواتها في التأكد من إعادة هيكلة الأسواق بما يضمن بقاءها ضمن نطاقها الاقتصادي، ويغري حلفاءها بالبقاء قريبين منها، محتاجين إليها على الدوام، وبنفس الطريقة التي عملت بها على خنق محيط الاتحاد السوفيتي، فإنها اليوم تعطل على الصين حسم إقليمها، بالتحالف مع تايوان والهند وغيرها.
هذا هو نموذج أميركا، الجمع بين الإخضاع عبر التحالفات، والتدخلات العسكرية المباشرة، فحيث لم تنفع الجزرة كانت تتدخل العصا. خذ مثلا تدخلها في قلب حكومة مصدق في إيران، ومنعها لصعود الأحزاب الشيوعية في غواتيمالا، وجمهورية الدومينكان، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والحرب في كوريا، ثم حربها التي خرجت منها على وقع ضربات فيت كونغ في فيتنام“.
كان صديقي يسمع هذا، وهو معجب بالطريقة التي استطاع بها الأميركان السيطرة على العالم، وينتظر النقطة التي سيختلف معي فيها.
“ولك أن تتخيل، أن البلد الذي يسيطر على العالم، يشكّل 5% من حجم السكان. وأنه كذلك، منذ 250 سنة من عمره لم يعش إلا 30 سنة منها في سلام، فهو على الدوام، إما في معركة، أو أنه يعد لأخرى. ليس سهلا أن تقود العالم بدولة كهذه”، قلت له.
وأضفت: “أنت تعرف أن الأميركان أنفقوا 916 مليار دولار في العام المنصرم على الدفاع العسكري، وهي النسبة العليا في العالم[2]، وتزيد على ما تنفقه بقية القوى العظمى على الدفاع مجتمعة. هذه نقطة قوة، صحيح، ولكنها في الوقت نفسه نقطة ضعف. كان بول كيندي (الذي فجر دراسات تراجع أميركا) قد ذهب إلى أن الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ، ابتداءً من الرومانية وحتى البريطانية، تسقط تحت وطأة التكلفة الاقتصادية العالية نتيجة إنفاقها العسكري (مشكلة التمدد الزائد Overstrech)، وعلينا أن نلاحظ كما لاحظ فيرغسون أن دين الولايات المتحدة تجاوز 110% من دخلها القومي، وهذا أعلى مما عرفته بريطانيا في نهاياتها”.
هنا، أمسك صديقي مقصًّا وقطع به حبل أفكاري، معلنًا العودة إلى الخلاف. “انهيار أميركا.. انهيار أميركا، آه؟”، ثم ألقى على الطاولة بابتسامة خفيفة. “هذا يشبه اعتبار كل ارتفاع لدرجة الحرارة في الجسم، علامة على قربه من الموت“.
أوهام التراجع: قد كان هذا كله من قبل
سألت صديقنا بشكل مباشر: “قل لي، وأنت القادم من بطن الوحش، ألا تبدو آثار التراجع على الإمبراطورية الأميركية؟”.
نظر إليّ، وبدا على محياه أنه سبق أن خاض هذا الحوار عشرات المرات من قبل: “هذا النقاش الذي سنخوضه الآن لن يختلف عن نقاش كان يجري في الخمسينيات من القرن العشرين. يمكنك أن تراجع وثيقة الأمن القومي الأميركي (NSC) في تلك الفترة، ستجد أنها تحذر من الفجوة المتزايدة بين القوة العسكرية لأميركا والتزاماتها بوصفها قوة عظمى، وأن «هذه الفجوة إذا استمرت فمن شأنها أن تضع العالم الحر في خطر الانهيار في مواجهة الاتحاد السوفيتي». لقد كانت الوثيقة، تصوّر أن النظام الأميركي يواجه خطرا محدقا لم تعرفه أميركا من قبل”.
“دعني أسمعك هذا الاقتباس”، قال لي، وتناول هاتفه، وراح يكتب على “غوغل” بعض الكلمات المفتاحية، ثم قال “اسمع” وبدأ يقرأ: «أمريكا هي قوة عظمى متدهورة وخائفة من أن تتورط في قضايا العالم الثالث، وأصبحت غير قادرة بوضوح على أن تفرض هيمنتها…». “خمّن أي سنة قيلت هذه الجملة؟ تبدو كأنها قيلت الآن، أليس كذلك؟ إنها لماوتسي تونغ“. قال ذلك، وانفلت منه الضحك، كأنه يسخر من تاريخه لا من “الرفيق ماو”!
“ستقول لي: لقد خرجت أميركا مذلة من أفغانستان على يد مقاتلي طالبان (وأنا لم أقل هذا، لكني كنت على وشك قوله فعلا)، هذا صحيح، لكنها خرجت مذلة على يد المقاتلين الفيتناميين أيضا، وماذا حدث؟”.

وأكمل كلامه: “كان عقد السبعينيات فظيعا، إذ فقد الاقتصاد صدارته، وتحول فائض التجارة إلى عجز تجاري، ونضبت الاحتياطات المالية. أتذكر، لقد قال كيسنجر وقتها ناعيا التجربة برمتها: «إنها الذروة لحضارتنا… والتاريخ ليس إلا حكاية الجهود الفاشلة للبقاء». إنه عقد الأزمة الأكبر، فقد شهد استقالة أول رئيس بسبب فضيحة “ووترغيت”، وارتفاع مفزع لأسعار النفط نتيجة استخدامه سلاحًا ضدها، وهو الذي ترك شعورا بالمهانة وخوفا على المستقبل لدى الأميركيين. في تلك الأوقات، كتب كارتر في مذكراته: «إن الشعب الأميركي كان في غاية الأسى من أن أزمة أمته العظمى على وجه الأرض قد سببتها دول صحراوية»، في إشارة إلى السعودية وإيران. ماذا كانت نتيجة كل هذا؟ ها ! أخبرني؟“.
قال وكأنه يعلن النتيجة للمرة الأولى: “انهيار الاتحاد السوفيتي“.
ولم يقف عند هذا الحد، بل أضاف: “والصين كذلك، تغيّرت بعد أن تعلمت الدرس، فتخلت عن صلابتها الأيديولوجية ودخلت في منطق النظام العالمي الذي صممته أميركا. من يبشرون اليوم بصعود الصين لا ينتبهون إلى أنها تصعد على درجات سلم صممته أميركا.
يا صديقي، لقد انفردت أميركا في التسعينيات؛ موسعة الناتو شرقا، ودافعة معظم العالم لتبني إجماع واشنطن، وكتب العديد من الكتاب شتما لفوكوياما عندما أعلن نهاية التاريخ. النموذج الليبرالي انتصر في السياسية والاقتصاد، لقد أوسع الجميع هذا النموذج شتما، لكن كلهم في قرارة أنفسهم كانوا يصدقونه، مشاعرهم تصدقه، والأهم سلوكهم اليومي يصدقه“.
ولمّا قال هذه الخلاصة، نظر إليّ، فأحس بتصنيف له قد اختمر في ذهني، فلم يصبر عليه حتى استدرك: “اسمع، لا أريد أن أبدو بمظهر عبد المنزل وكل هذه التصنيفات الجاهزة، أنا فقط أحاول أن أكون واقعيًّا، من يتجاهل حقيقة أن السماء تمطر في الخارج، تفاؤلًا بصفاء الطقس، لن يجني لنفسه إلا البلل”.
“أنت استشهدت منذ قليل بكاندي، أليس كذلك؟”، سألني ولم ينتظر الإجابة.
“دعني أقل لك، إن أدبيات أفول الغرب قديمة جدا، كل أزمة ستجد خلالها العشرات من المقالات والكتب التي تبشر بتراجع ليس فقط أميركا بل السيطرة الغربية برمّتها… صدّقني، ثمة الكثير من التفسير الرغبوي في كل هذا. الكثير من المتضررين من السيطرة الأميركية في العالم يعتقدون أن كل مؤشر للتراجع يشبه بالضرورة قطعة الدومينو، التي تشتغل بمنطق حتمي نحو الهاوية.
يمكن أن تتراجع في سنوات وتتقدم بعدها، تتعرض لأزمات وتخرج منها أقوى، يتعرض شكل سيطرتك لتحدٍّ فتعيد تكييفه، وهو ما قد يبدو للبعض ضعفا، لكن من يفهم فضيلة المرونة، لا يمكنه إلا أن يعجب بالطريقة التي ينجو بها هذا النظام باستمرار“.
صمت هنيهة فهممت بأخذ دوري في الحوار، لكني رأيت عينيه كأنهما تتأملان ما قال، استعدادًا لعودة لسانه إلى الانطلاق مرّة أخرى، فأدركت أني إذا تكلمت لن أتكلّم إلا لنفسي، فآثرت احترام سكوته، وفعلًا، ما هي إلا ثوانٍ حتى عاد وانطلق: “لقد عانت أميركا أزمات اقتصادية حادة في عقود (1890-1930-1970) واستطاعت بعدها أن تعود أقوى مما كانت، والآن ما زلنا نعاني من تبعات أزمة (2008)، لدينا سنوات من الركود والنمو المتباطئ، هذا صحيح، لكن المركز الاقتصادي للولايات المتحدة لم يتغير. انظر آخر أربعة عقود، ستجد نفسك أمام الحصة نفسها، ربع الإنتاج العالمي هو من نصيبها. وما زالت في نفس المركز، صعود الصين التهم من كعكة أوروبا واليابان، لكن ليس من أميركا”.
قاطعته هنا: “أنت تتجاهل التناقضات داخل المعطيات الاقتصادية، قلت لك إن الأرقام تكذب أكثر من غيرها؛ لأنه لا يشكك فيها أحد. ثمة تناقضات حقيقية تزداد بين النمو والتوزيع لهذا النمو، بين الإنتاج السلعي (الذي يؤسس اقتصادًا حقيقيًّا) والاقتصاد المالي، وهذا الأخير يشكل معظم شكل الاقتصاد، ولا تخفى عليك هشاشته، خصوصا وقت الأزمات والحروب، إضافة إلى الممكنات المدمرة التي تحملها فكرة تنمية المال من المال، وهذا بالأساس تخصصك ولا أريد أن أتعدى عليه”.
أجاب بعجلة: “هل وضع الصين أفضل؟ وعلى ذكر الصين، نحن أمام نمو سريع بلا شك، وهو من ناحية التسارع يصب في صالحها، لكن لنتذكر أن الصين كانت أكبر اقتصاد عالمي في بداية القرن التاسع عشر. قوة الاقتصاد شيء وتحويل هذه القوة إلى نفوذ سياسي شيء آخر. أما اليوم، فمن ناحية اقتصادية ما زالت تواجه مشكلتين رئيسيتين: الحفاظ على معدلات النمو، ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، و(في هذين الجانبين) ما زالت أميركا متفوقة عليها بكثير“.
“دعنا من الاقتصاد، ودعني أسألك“، قال لي. “هل تعرف اسم فيلم صيني، كتاب، مفكر، أو حتى فكرة صينية عن العالم. إذا كنت تعرف اسم أو اسمين، وغالبا أنت تلفظهما بشكل خاطئ، فأنت تعرف العشرات عندما يتعلق الأمر بأميركا. ليس لدى الصين فكرة تبيعها للعالم، وهي لا تنتمي لفضائنا الحضاري، وكونك قويًّا اقتصاديا وعسكريا لا يكفي لحكم العالم. لكن أميركا لديها أفكار وثقافة، وهو ما نسميه بالقوة الناعمة؛ أن يحبك العالم، أن يعجبوا بك، أن يكون لديهم طموح بأن يصبحوا مثلك. ما زال الناس يموتون في البحور والمحيطات وهم يحاولون الوصول إلى أميركا، هل سمعت عن أحد مات غرقا في الطريق إلى الصين؟!
يا رجل، حتى نُقّاد الحضارة الغربية لا يجري الاعتراف بهم إلا عندما يمرّون بالمؤسسات الأميركية. انظر إلى كل دراسات التابع الهندية؛ من رانجيت إلى سبيفاك إلى هومي بابا، وانظر إلى نقاد الاستشراق؛ من إدوارد سعيد إلى وائل حلاق، من أين ينتجون المعرفة؟ وكيف يحصلون على الاعتراف؟
المضحك أكثر أن بعض الأصدقاء يبشرون بالنموذج الروسي، أوه، هذا ما لا أريد أن أخصص له حصة من النقاش، فقط عليك أن تعلم أن كاليفورنيا وحدها تنتج اقتصاديا أكثر مما تنتجه روسيا بأكملها!! هؤلاء لأسباب نوستالجية، لا علاقة لها بالسياسة، يظنون أن روسيا هي نفسها الاتحاد السوفيتي”.
ثمّ ختم فكرته بالسخرية: “تخيل أن يعيدوا لك المقاهي القديمة مع الرفاق القدماء، ثمّ تجدهم يتكلمون بالطريقة القديمة نفسها! اليسار اليوم في مقاربته لموضوع صعود روسيا، يشبه بطلة فيلم “جود باي لينين”؛ تغير العالم كليا من حولها، لكن عالمها هي تحديدا بقي كما هو“. وأخذ يضحك.
أميركا بين طائرتين
السبت 14 سبتمبر/أيلول 2019، استهدفت طائرات مسيرة منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية في المنطقة الشرقية من المملكة. كان الاستهداف الإيراني رفعا مفاجئا لقواعد الاشتباك، لكن الأكثر مفاجأة كان إجابة الرئيس الأميركي وقتها دونالد ترامب، حين سئل عن الردّ الأميركي، فأجاب: “لقد حدث هذا في مكان بعيد عنا”.
تستورد أميركا من نفط الخليج حوالي 5%، في حين كانت تستورد 20% عام 2012، فحاجتها إلى النفط الخليجي اليوم لم تعد مثلما كانت في السابق، أما الصين فتستورد 40% من نفط الخليج. مع ذلك، ما زال الخليج منطقة نفوذ أميركي، ومسؤولية ضبط إيقاع وأمن الإنتاج جعلته من مسؤوليتها، لأنه في النهاية سيؤثر في العالم كله، وفكرة أن هذا “حدث بعيدا عنا”، أعطت انطباعا لأصدقائها وأعدائها على السواء، بأن تراجعا ما قد حدث. لاحقًا، سمعنا عن تقارب سعودي إيراني برعاية صينية!
وفي السياق ذاته عام 1938، كان جنرالات هتلر مشغولين بخطة “غرين” المعدة للهجوم على تشيكوسلوفاكيا، ولمّا لم يجدوا ما يردعهم؛ نفّذوها. كان تجاوزا لقواعد اللعبة وقتها، ومؤشرا حقيقيا على قوة هتلر وتراجع قوة خصومه، وحين سئل نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء بريطانيا، عن ذلك، قال: “لقد حدث هذا في مكان بعيد عنا”. لكن هتلر قرأ ذلك جيدا، ممّا أغراه بالاستمرار.
لذا، فإن مقدمات الحرب العالمية الثانية بدأت مع القرارات المترددة التي سبقتها في وضع حد لهتلر وتصاعد قوته.
المهم هنا، أن أول من يقرأ تقهقر الدول العظمى من الدول، هي الدول التي بأمس الحاجة إلى حمايتها، فدول الأطراف تعرف مبكرا مؤشرات التراجع في المركز.
بعد أن سردت لصديقنا هذا التشابه بين القصتين، أخذت أشرح له فكرتي: “ستبقى على رأس القيادة حين يخافونك ويرغبون فيك، أما عندما تكف عن الإخافة وإثارة الإعجاب، فإنك تدريجيا تبدأ تأجيل المشاكل التي عليك حسمها، تحت فكرة أننا لم نصل بعد إلى نقطة التصعيد الصفري، مضحيا برصيد ردعك وهيبتك”.
ثمّ ضربت له مثلًا: “لا يمكن فهم جرأة الحوثي على إغلاق البحر الأحمر إلا كامتداد لحادثة أرامكو، وفشل تحالف حارس الازدهار سيمنح خصوم الولايات المتحدة جرأة أكبر. واللحظة التي لا يعود فيها ضعفاء العالم يصدقون الأساطير التي تصوغها أميركا عن نفسها، تبدأ قوة ردعها التآكل. ونحن ننتمي لجيل شهد محدودية قدرة أميركا على التدخل مرات ومرات، وشهد مهانتها كذلك.

أما طائرة 11 سبتمبر/أيلول 2001، فلقد ضغطت على كبرياء أميركا وأطلقت جنونها في غير الاتجاه الصحيح، الذي كان عليها التركيز فيه، وذلك بحسب ما تعلنه عن أولوياتها. كان حادثا أفقد الأميركان الإحساس بالوجهة، ولم يستفيقوا عليه إلا وقد أصبحوا بدون قيادة. كانت مناظرة بايدن وترامب مناظرة بين خرف ومجنون، هل هذه هي قيادة العالم الذي تبشرني بعقلانيته في تجاوز الأزمات؟!”.
استفزّه تساؤلي الساخر، لكني لم أكترث، وأكملت: “لقد انشغلت أميركا بحروب غير إستراتيجية، أنفقت فيها الكثير من أموالها وسمعتها، وغذت خلالها نزعات تصاعدية في عدائها، ولكن أيضا أتاحت المجال لصعود الصين وروسيا في ظل هذا الانشغال غير المجدي. أما الصين فواصلت نموها بصمت، كما سعت روسيا لحسم إقليمها بمهاجمة جورجيا ثم القرم ثم أوكرانيا.
في المحصلة، خرجت أميركا من أفغانستان تاركة حكمها لطالبان، وخرجت من العراق تاركة حكمها لإيران، بل فتحت المنطقة أمام الإيرانيين بإسقاط نظام صدام حسين، ولم تحقق أي هدف إستراتيجي من حروبها آخر 25 سنة”.
“ثم إنك تسألني عن الفكرة التي تملكها الصين للعالم”، قلت له وقد كان يظن أن مجادلته عنها مفروغ منها عندي. “حسنا، إنك تنسى أننا في عصر لم يعد أحد فيه يقدم أي فكرة، لا يتعلق الموضوع بالصين وحدها، إن النظام العالمي برمته، بمن هم على هرمه وبمن يتنافسون على هرمه، لم يعد لديهم ما يقدمونه قيميًّا، طبعًا إن افترضنا أنهم كانت لديهم قيم في السابق. الفكرة ليست في انتظار من سينوب أميركا، بل في أن الشكل الذي سيأخذه الصراع على القمة سيرخي قبضة السيطرة على منطقتنا، وربما يتيح لنا متنفسا في صعود السلم الذي يخصنا.
أما موضوع تصدير الأفكار الذي أشرت إليه، فقل لي بربك وأنت تعلم أن من يتنازع على أميركا اليوم يسار جديد ويمين جديد: ما هي الأفكار التي يقدمها هذان التياران؟ ها؟ لا يمكنك أن تسمع جملة واحدة تخرج منهما، دون أن تسمع في خلفيتها صوت اصطدام رأس البشرية في القاع. اليسار الجديد يضحي بـ”المنجز” الليبرالي الأكبر: الفردية والحرية لصالح الحشود المهووسة بالجنس والرغبة. يا صاحبي، والله إن النازية تعتبر نسخة محسنة من حجم القمع الذي تحمله هذه الفئات لسكان المعمورة.
ثمّ ما الذي يقدمه اليمين الجديد؟! هوس للعرق وعصاب ضد اللاجئين، وشعارات بدون مشاريع. في اللحظة التي تحول فيها المهاجر إلى لاجئ، تكون فكرة أميركا القائمة على الهجرة قد ضربت.
“وعلى ما يبدو في هذين التيارين من اختلاف، فإن بينهما شيئًا مشتركًا”، قلت له، وبدا على وجهه التعجّب! “المشترك بينهما أنهما يقدمان خطابا للغرائز دون المرور بالعقل، ويعلنان وصول الانحدار الغربي إلى مآله الأخير، وعلى مذبح الهوى هذا تجري التضحية بكل إرث.
وحدهم الذين ما زال لديهم صلة بوحي السماء هم من يستطيعون تقييم هذا الاعوجاج، فصدّقني، لا يمكنك تقويم شيء بدون وجود مسطرة سابقة على وجودك، تكون معيارا لما ينبغي أن يكون عليه الشيء. ونحن يا صديقي الورثة الباقون لما ينبغي أن يكون عليه هذا العالم بعد فساده، وهذا قدر تكليفي ثقيل أكثر منه إضفاء لمدح أو رفعا من شأن الذات”.
كان الاقتصاد الذي بنى عليه صديقنا أرضيته للمجادلة، والذي حاول جرّي إليه بوصفه مربّعًا آمنًا له يتقن اللعب فيه، آخذًا في الاضمحلال أمام القضايا الأخرى، وكأنه أدرك فجأة أن أميركا ليست اقتصادًا فقط: “إنك بالمؤشرات التي ذكرتها ما زلت أسيرا للطريقة التي ينظر بها النظام إلى نفسه، إنك كمن يحاول التأكد من نجاح العملية الجراحية بسؤال المريض الذي تحت التخدير عمّا إذا كان لا يزال يشعر بالألم؟!
لكنك تعرف، أن التجارب في النهاية تنهار -غالبا- ليس نتيجة قلة الثقة بالنفس، بل بفائض من هذه الثقة. يمكن للتراجع أن يحدث دون أن ينتبه أكثر الناس عناية به، ولا يعني القدرة على تجاوز الأزمات -أكثر من مرة- أن صفتك الخالدة هي تجاوز الأزمات، بل قد تمكر بك الأزمات من هذه النقطة تحديدا؛ نقطة الثقة الكاملة بالقدرة على حلها.
ربما لم تدرك بريطانيا أنها لم تعد قوة عظمى إلا بعد فشلها في العدوان الثلاثي على مصر، وربما فوجئت بأن قوى أخرى أصبحت أقوى منها، وأنها لكي تحترم سنها عليها أن تفسح المجال لصعود الآخرين، وأن تتبع حماس الشباب حتى لا يدوسها هذا الشباب القادم بقوة”.
“هل كانت النخب التي تعيش ببريطانيا تعلم بأفولها؟ هل استشعرت قبل الأفول أم خلاله أم بعده؟ هل كانت داخلها أصوات تؤكد أننا مررنا بأصعب من هذا وتجاوزناه فلا داعي للفزع؟!”، تساءلت، ولم أنتظر جوابه.
“خذ مسألة فتور حماس الأجيال القادمة للدفاع عما ورثته من قوة، بل عدم إدراكها لما ورثته، هذا ضروري ومركزي في بذل التضحيات اللازمة لبقائه. أليس هذا قانون الانهيار الدائم؟ جيل أول مؤسس ومضحٍّ، ثم جيل بناء التقاليد والمؤسسات، ثم جيل الرفاه الذي لم يدرك الصعوبات ولم تصقله، ولم يعرف المخاوف لتحفزه. كتب تشرشل في مذكراته: «أجرى نادي خريجي أكسفورد سنة 1933 استفتاء حمل هذا السؤال: هل أنت جاهز للقتال من أجل بريطانيا العظمى؟ غالبية الإجابات كانت بالنفي».

واليوم هناك جيل بأكمله لا يرى أن ثمة حلمًا أميركيًّا لكي يمنحه روحه دفاعًا عنه. بل يغلب على هذا الجيل، عدم الثقة في هذا النموذج وفقدان الانبهار به، فتوزع الجيل على انتماءات هوياتية فرعية عابرة، لا تغذي اكتساب صفات القوة ومعالي الأمور، بل تجعلها محط سخريتها”.
وأردفت: “ليس هذا فقط، فالمجتمع الأميركي اليوم في أشد لحظات انقسامه، حتى إن شخصا مثل فوكوياما الذي استشهدت به للتو، اعتبر أن المؤشر الحقيقي للتراجع هو أن الانقسام الداخلي أصبح حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين، لدرجة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجمهوريين يعتبرون الديمقراطيين أكثر خطرا على أميركا من الروس والعكس صحيح”.
وحتى أضعكم في صورة هذا النقاش، تعرّضت مع صديقي لنقطة نظريّة الطابع، ورأيت أن أوضحها لفهم الطريقة التي تعمل بها الديمقراطيات، وذلك تجنبًا لأي سوء فهم بيني وبينه: “ثمة حجم للخلاف بين التيارات، إذا ما صار حادًّا، يصبح فوق قدرة الديمقراطية على حله.
الديمقراطية تنظم الخلافات التي على سطح الحياة السياسية، أما ثوابت الأمة فإنها تُحسم مع المؤسسين والأوائل. مع الوقت، تتوالى التقاليد المؤسساتية أو ما يعرف بالدولة العميقة على ترسيخ ثوابت الأمة وحماية جوهرها، وتشمل هذه الحماية حمايتها من الديمقراطية نفسها، من جهل الطارئين أو جنوح الشاردين في أحلامهم عن إمكانية التغيير الجذري من خلال صناديق الاقتراع.
عندما توضع الثوابت محل استفتاء وينقسم الناس عليها، لا تعود الديمقراطية قادرة على التعامل معها، مع مهمة بهذا الحجم، وهذه هي المشكلة الكبرى التي عانينا منها خلال ثورات الربيع العربي؛ ذهبنا نحسم ثوابت الأمة عبر صناديق الاقتراع!”.
من “ربّان العالم الحر” إلى رجل إطفاء حرائقه
لم أدع صديقنا يقاطعني، فلقد أخذ حصّته من الكلام حتى خشيت عليه من أن يشرك ويجعل أميركا إلهًا. لذا، تعمّدت تكسير هذا الصنم في نفسه، وقلت له: “يا صديقي، حتى قدرة أميركا على أن تقود مؤسساتها فقد تحولت إلى محط سخرية.
انظر جيدًا، إنها تتعرض لاستنزاف في شرعيتها بشكل مستمر، وهي اليوم في أسوأ حالاتها، خصوصا مع تمسكها بحليفتها “إسرائيل”، التي لا تكف عن إحراجها، من محكمة الجنايات الدولية إلى تجريم الأونروا، ومن معسكرات الاعتقال إلى المحارق والإبادات الجماعية. بدت “إسرائيل” كدولة مارقة على النظام الدولي، ولم تنجح أميركا في صنع مسافة من مروقها ولا حتى في كبحه، بل عززته مضحية بمكانتها الإستراتيجية لصالح طريق فرعي قد تكون عواقبه وخيمة ومكاسبه في كل الأحوال أقل من خسائره.
تحولت “إسرائيل” من مشروع يحمي مصالح أميركا إلى مشروع بحاجة إلى حمايتها، ولقد أنفقت أميركا على “إسرائيل” منذ قيامها 260 مليار دولار. وكان طوفان الأقصى كاشفا عن هشاشة هذا المشروع وعجزه عن القيام بالدور المنوط به. أنت أمام حليف ضعيف ومُحرِج ومكلف لك، ومع ذلك يقف أعضاء الكونغرس يصفقون له عشرات المرات، على وقع التعطش إلى الدم وغياب العقل والقيم.
لقد احتاجت أميركا إلى تعجيل دمج “إسرائيل” بالمنطقة، لكي تتجه شرقا وتركز على التحدي الأهم وهو صعود الصين، لكن “إسرائيل” تشدها مجددا في حروب غير إستراتيجية كما فعلت سابقا طائرة برج التجارة. لكن كل خطوة تفعلها هي متأخرة عن وقتها، وكما شخّص تقرير لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني، فإن خطة بايدن للأمن لعام 2022، متخلفة عن حجم الأخطار والمهام التي تحيط بها.
إن مشروع التطبيع بالطريقة التي صممته أميركا بها، وفشلها في رعاية عملية ولو شكلية للدولة الفلسطينية، عمّقا استفزاز المقاومة وعجّلا بمعركة الطوفان، وأغرقا أميركا مجددا بقضايا بعيدة عن أولوياتها، ومن طائرة التجارة حتى الطوفان، تحول الدور الأميركي من “ربان العالم الحر” إلى رجل إطفاء حرائقه، معتمدا منهجية محاصرة الحريق بالحريق”.

ولمّا رأيت أني أثقلت عليه بالنقد، متعاملًا مع حججه التي طرحها، أخذته إلى منطقة أخرى: “إن رصد تراجع الدور الأميركي ليس موضوعا أكاديميا، صدقني، هو أهم من ذلك بكثير. لدينا اليوم فرصة تاريخية لاستعادة دورنا، ومع أني مدرك تماما لحجم قوتها، وضعفنا، فإنني مدرك أيضا كوامن الانهيار فيها، وكوامن النهوض فينا.
قبضتها تضعف، والفوضى قادمة لا محالة، الحرب التي لا يريدها أحد قد تبدأ في أي لحظة، بأي خطأ كان، وحجم الصدفة في هذه الحالات مؤثر جدا، ومنطقتنا عانت كثيرا من هذا النظام العالمي وظلمه. ولطالما كانت أراضينا وأجساد أهلينا مكانا لحل تناقضات القوى الكبرى، بعيدا عن أراضيها، وبقدر ما ترك هذا جروحا فينا، فإنه منحنا كنوزا مهمة يمكننا الاتكاء عليها: الخبرة اللازمة لفهم ما سيأتي، والرغبة العارمة في أداء دور فيه.
يا صاحبي، لقد كان عجزنا هو كنزنا، وبمقدار ألمنا بهذه الحقيقة كنا نتدرب على تجاوزها. الفرن المفتوح لا يخبز، ونحن أغلقت علينا الدنيا وأصبحنا أرغفة ناضجة”.
“أنا مضطر هنا إلى مقاطعتك”، قال لي. “أفهم تماما ما تقوله، لكن كل الحسابات المنطقية تستبعده“.
قلت له: “بالعكس تماما، كل الحسابات المنطقية تدعمه، لم نكن عقليا أقرب من اليوم إلى حدوث التغيير الكبير، على شرط أن تفهم العقل بمعناه الأوسع؛ المعنى الذي يندرج داخله احترام الغيب وغير المتوقع بوصفهما سببين حقيقيين وواقعيين، نحن جيل شهد بأم عينيه العديد من الهجمات على القوى الكبرى وإذلالها بما لم يشهده أجدادنا، آخرها كان طوفان الأقصى، ألم يعنِ لك ذلك شيئا في روحك السياسية؟”.
أجابني: “نحن جيل شهد حجم نكسات أكثر بكثير مما شهد أجدادنا، ألا يعني لك ذلك شيئًا في روحك السياسية؟”.
خاتمة: في مساوئ القرب من الظاهرة
حين سئل الرئيس المكسيكي الأسبق بيدرو فارغاس، وبلاده غارقة في المشاكل أوائل الثلاثينيات، عن حقيقة أزمة المكسيك، أخذ يفكر قليلا ويتمتم: “أزمة المكسيك”. ثم أجاب: “أزمتها أنها قريبة جدا بحدودها من الولايات المتحدة، وبعيدة جدا بروحها عن الله”.
وصديقي لديه نفس مشكلة المكسيك تماما، قريب من أميركا، ومن شأن القرب أن يحجب الفهم ويجمد العين الناظرة على قوة المادة، وكذلك بعيد عن الله، ومن شأن البعد أن يعطّل فهم الكيفية التي تعمل بها يد الله في التاريخ، وبدون ذلك لا تمكن الثقة في المستقبل، لا تمكن الثقة في أنفسنا، ولن نتمكن من رؤية الفجر.. ولا من فهم سورته.
فقد كان هذا كلّه من قبل أميركا وبريطانيا، وروما، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فقل لي: ألم تر كيف فعل ربك…؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ورد التعبير في موعظة الجبل للمسيح، “أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل”، ثم أصبح عبارة تشير إلى أميركا منذ هجرة البيورتانيين من إنجلترا نيو إنغلاند، ولاحقا عبرت الروح المادية بتأويلها بعيدا، حين جعلتها تعبيرا عن “الحلم الأميركي” نفسه.
[2] زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري العام الماضي بنسبة 2.3%، وهو ما يفوق الدول العشر التالية لها على سلم الميزانية الدفاعية مجتمعات.