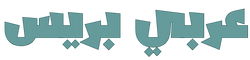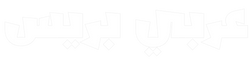من معذبي الأرض إلى أحباب الله.. التائبون بعد السابع من أكتوبر | سكون

“هل تسمح لي بالتدخين؟” سألني معتز
لا تبدو سجائر عاديّة، أخشى أن تؤثر في وعيك قبل الحوار؟
“بالعكس، بدونه لن تكون هناك اعترافات، ولن أستطيع أن أعبر لك بكل وضوح عن أفكاري!” قالَ لي مغريًا.
قمتُ من الكرسي الذي بجانبه، وانتقلت إلى أبعد نقطة في المجلس الذي استضافنا فيه صديق مشترك، بعد أن قدّمنا كلًّا منا للآخر، ثم غاب عنا لينجز بعض مهامه.
لم يتأخر معتز في إعداد سيجارته العجيبة، فتح حقيبته اليدوية وأخرج جواز سفره، لم يكن جواز سفرٍ عاديًّا، لا أوراقَ فيه، فتح الجواز الذي ثبّتَ فيه صندوقًا معدنيًّا مستطيلا بحجم علبة سكاكر صغيرة، فتح العلبة وأخرج مادة صلبة بُنيّة اللون بحجم بذرة خوخ، ثم أخذ يحكها على حديدة مسننة معلقة بطرف الجواز بسلسلة كتعليقة المفاتيح، أخذ رذاذ القطعة يتجمع في ثَنيّة الجواز حيث تلتقي الصفحة الأولى بالصفحة الأخيرة، ثم مدَّ يده إلى حقيبته وأخرج كيسَ التبغ، أخذ منه حفنة بثلاثة أصابع، كانت كميّة التبغ موزونة، بحيث أصبحت تشكل نصف الخلطة تقريبًا مع تلك المادة، عاد إلى صندوق عجائبه الصغير وأخرج منه ورقة سجائر مع المصفاة الإسفنجية، ثبّت المصفاة على الورقة وثناها بيد واحدة وأمسك جوازه باليد الأخرى ثم صبّ من ثنيّة الجواز إلى ثنيّة الورقة، ولفّها. ألقاها إلى فمه، وأشعلها بسرعة، بعد نفس عميق، نظر إليّ وقال “أنا جاهز لأخبرك بكل شيء!”.
“قل لي أولًا، هل هذا جواز سفر حقيقي؟”
“نعم، هذا جوازي العربي، حصلت على جنسيّة أخرى قبل سنوات، فانتقمت من هذا الجواز الذي كانت تُغلق أمامه كل مطارات العالم، بأن صيّرته حقيبة للكيف، الآن صار يأخذني إلى حيث أريد!” قال هذا وهو يعيد جوازه إلى حقيبته وينفض ما تساقط على الأريكة.
“في الحقيقة، لا أريد أن أجري معكَ حوارًا كما فعلت مع كثير قبلك، أريد أن أسمع قصتك، لن أزعجك بالأسئلة، ما دام ما تشربه يعين على الصراحة فلا أريد أن أحدده بأسئلتي فيفوتني شيء من الاعترافات، أخبرني بحكايتك منذ البداية” قلت هذا وتربّعت في جلستي على الأريكة المقابلة له استعدادًا لمقابلة طويلة، بعد أن قربت منه هاتفي للتسجيل، وألقيتُ بمفكرة أسئلتي جانبًا!
“أنت صحفي شاطر!” قال هذا بضحكة مبحوحة “طيب يا سيدي، أنا معتز، عمري 34 سنة، ولدت في الإسكندرية وفيها عشت، أعمل اليوم في الإعلام كمصمم، ولديّ عمل جانبيّ هو أحبُّ إليّ من وظيفتي وهو أني كوميديان أقدم عروضًا مضحكة”.
“هذه بداية مخيّبة يا معتز، أنا هنا لسماع الاعترافات، لا لتقديم عرض وظيفي” قلتُ له باسمًا ومستفزًا!
“حسنًا، خذ أول اعتراف: حين كان المصريون في ميدان التحرير في 2011، يطالبون بإسقاط النظام، كنت جالسًا على شاطئ الإسكندرية أدخن سجائري وأسيح في عوالمي!”.
أنت أول مصري أسمعه يقول إنه لم يشارك في ثورة يناير.
“لم تكن ثورة، كان تجمعًا غاضبًا، أنا يائس من مجتمعي، لم أكن أظن أنه يستطيع أن يتغيّر، حتى لو جاء غير مبارك، لن يتغير الوضع، كلنا نتشابه إلى حد بعيد، المشكلة ليست فيمن يحكم، المشكلة من هي الجماعة المميزة التي ستخرج شخصية مختلفة تستطيع تغيير واقعنا بشكل حقيقي!” ثم رمى بنظره إليّ، أخبرني يا حضرة الصحفي، بلادك تمرّ باضطرابات الآن “هل تستطيع أن تسمي لي شخصية واحدةً تعتقد أنها قادرة على إصلاح البلاد إذا استلمت غدًا الرئاسة؟”
بعد ثوانٍ من التفكير، واريتُ عجزي عن الإجابة بقولي “أنا هنا لطرح الأسئلة، لا تأخذ وظيفتي من فضلك”.
“أرأيت! لا يوجد. نحن مجتمعات تحتاج إلى تغيير قبل أن تطالب بتغيير من يديرها، لأن من يديرها لن يكون من غيرها!”.
هذه السلبية السياسيّة من أين اكتسبتها؟ سألته محاولًا استعادة إدارة الحوار.
“أنا ابن لعصر مبارك، العجز وانسداد الأفق، وعدم الجدوى، والجهد القليل هو طابع الواقع الذي عشت فيه” بعد لحظة صمت ورفع رأسه إلى السقف كمن يفكر في إجابة أدق “شوف، أنا وعدتك بالاعترافات، أظن أن الأمر أعمق في شخصيتي، هذا ما تسميه بالسلبيّة السياسيّة، أسميه أنا بوضعيّة ’’ما ليش دعوة” [لا علاقة لي]. نشأت في أسرة متوسطة تعمل في نجارة الخشب، ولديهم شركة ليست بالكبيرة، كنت أحب أخوالي وأحب أعمامي، ولأني لا أريد أن أخسر أحدًا منهم، كنت دائمًا أقول لهم في الخلافات التي تحصل بينهم في العمل “ما ليش دعوة” ولا آخذ موقفًا في أي خلاف، أو أصطفّ مع أحدهم ضد الآخر حتى لو كنت أعرف الجانب المخطئ، حتى لا أخسر أي طرف!”.
تخاف من اتخاذ القرارات؟
“جدًّا، والمشكلة ليست في عدم اتخاذها، مشكلة القرارات أنها تحتاج إلى اتخاذ، وتحتاج كذلك إلى توقيت صحيح، كل تأجيل في اتخاذ القرار يزيد من صعوبته مع مرور الزمن”.
“لا أظن أني فهمت تمامًا ما تقوله” قلت وأنا أشعر بالخوف من أن مفعول ما يشربه بدأ يؤثر في قدرته في التعبير.
“سأضرب لك مثالًا، تناولي للمخدرات في سن 16 سنة كان حماقة مني، ولكن كان بإمكاني أن أتخذ قرارًا بالتوقف بعد أول سيجارة وينتهي الأمر بسهولة لأني كنت أعرف أنه عمل خاطئ. لكني بقيت أؤجل هذا القرار، حتى صار شاقًّا جدًّا عليّ. الآن في محاولاتي للتوقف أشعر بالحقد على معتز المراهق لأنه ورطني هذه الورطة، فالتوقيت في اتخاذ القرار مهم بقدر أهمية اتخاذه، فهمت؟”
فهمت، حسنًا بهذا المنطق، ألا تلوم نفسك أنك لم تشارك في الثورة؟ فربما كان ذلك قرارًا سيغيّر حياتك!.
“يا سيدي لن يتغيّر شيء، لقد دخلت إلى الخدمة العسكريّة في 2012. حين ذهبت للتسجيل في بعض الدوائر، كانت صور مبارك ما تزال معلقة على الحائط. في مرة طلب مني الموظف القاعد على المكتب رشوة حتى يوقع على الورقة، قلتُ له: “مش احنا عملنا ثورة وتغيرنا وخلصنا من الفساد؟
ردَّ عليّ بكل هدوء وثقة: هم تغيروا نحن لم نتغير!”.
ودفعتَ؟ سألتُه
“لا طبعًا، مارست نوعًا آخر من الفساد، اتصلت بأحد معارفي واستخدمت المحسوبيّة، وتمت المعاملة، ألم أقل لك: المشكلة فينا نحن، لكننا نحاول تصديرها”.
“حين دخلنا الخدمة استقبلونا بالضرب “بالشلاليت” (= الأحذية) وقالوا لنا ألستم أنتم من عملتم الثورة؟”
لكنك دخلت إلى الخدمة الإجبارية، ينبغي أن تكون استفدت من العسكريّة في تعلم الانضباط والعيش لهدف سامٍ كحماية الوطن.
“كانت أسوأ فترة في حياتي، عشت أشهرًا من الذلّ والعذاب!”..
أين خدمت بعد الدورة التدريبية؟
“في مرسى مطروح”
هذا جيد، كنتَ على الثغر الشمالي؟!
“أيه يعني ثغر؟”
يعني كنت مرابطًا لحماية الحدود، الثغر: يعني المنطقة التي يُخشى هجوم العدو منها، وكانت حدود الدولة الإسلامية قديمًا تسمى ’’ثغورًا’’.
بعد ضحكة طويلة ومبحوحة قال لي: “تعرف، حين كنا على ’’الثغر’’” ونطق الثاء سينًا، “جاءنا أحد الضباط متفقدًا، سأله أحدنا بحماسة في غير موضعها، ما هي وظيفتنا في هذا المكان، نحن هنا منذ أشهر ولا نعرف ما المطلوب منا بالضبط؟
فقال له الضابط بنبرة غاضبة: “أنت هنا مطب، يدوس عليك العدوّ فيتأخر، حتى نتجهز له”، فأنا خدمتُ مطبًا على الثغر” وأخذ يضحك بصوت عالٍ جدًّا.
دعنا نعد لموضوعنا، السابع من أكتوبر هل غيّر فيك شيئًا؟
توقفت ضحكته مباشرة، كأنه سمع شيئًا يقدّسه.
“السابع من أكتوبر غيّر العالم، ولم يغيرني أنا فحسب. لقد أنهى السابع كل أساليب الاعتذار التي يمكن أن يبرر بها المرء عجزه، وقلة حيلته، لم يعد هناك أي مبرر مقبول، لقد صنع مجموعة من الشباب المحاصرين، ما لم تصنعه أي دولة عربية بكل قوّاتها. ليس هذا فحسب، بل عرّى السابع من أكتوبر العالم أمام نفسه، كل العالم! لم يعد أحد في هذه الأرض يستطيع أن يقول لم أكن أعرف شيئًا عن مظلومية الشعب الفلسطيني، لم يبقِ لهم السابع من أكتوبر إلا سؤالا واحدا: ماذا ستفعل لهؤلاء المظلومين؟”.
حدثني عنك بخصوص..!
“طرح عليّ سؤال الإدمان من جديد، وحفزني للتخلص منه، أريدُ أن أصبح شخصًا مفيدًا، لا يعجبني وضعي حين أقارنه بشباب غزة”.
أرى أنك لم تنجح تمامًا، قلتُ وأنا أشير إلى السيجارة في يده.
“هذه ثاني سجارة أدخنها هذا الأسبوع، كنت أدخن يوميًّا وبشكل مفرط. لم أبلغ بعد إلى الإقلاع التام، لكني عازمٌ عليه، بدأتُ السير نحو الإقلاع بعد السابع، ثم حصلت لي أشياء قد تهمك”.
أخبرني، قلتُ مستحثًا له.
“بعد السابع بدأت محاولاتٍ عديدة للإقلاع، لكني كنت أنقطع في كل مرة. في أحد الأيام، جاءني أحد الأصدقاء ليسمعني شيئًا كنتُ قد شربتُ شيئًا قبل وصوله، عندما جاء فتح لي جهازه وقال اسمع سجّل أخي مقطعًا مرتلًا، وفتح المقطع” قال معتز هذا وضغط على شاشة هاتفه فانطلق الصوت {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} كان صوتًا شجيًا للغاية، برقت عيون معتز، ثم أغلق التسجيل، يخيفني القرآن، منذ مراهقتي كنتُ إذا سمعت سورة الواقعة في البيت من مسجل والدتي، أتوقف يومين عن الشراب تأثرًا بما سمعت، ثم أضعف وأعود. حتى إني صرتُ أتجنب سماع القرآن.
بعد تلك الليلة وسماع مقطع أخي صديقي خرجت وحضرت لصلاة الفجر في الجامع، وأقلعتُ عن التدخين لأسبوعين. وكنتُ أعاني كثيرًا لأن آثار الانسحاب تجعلني أكره جميع الناس، ولا أرغب في التواصل مع أحد، ولكن عملي يقتضي مني نوعًا من التواصل. في يوم الجمعة دعاني أحد الزملاء للخروج إلى البحر لأنه أجّر مركبًا للاحتفال بعيد ميلاد طفله. وقال لي وهو يعرف مقدار حبي للأطفال، سيكون هناك الكثير من الأطفال لتعلمهم الرسم؟
“قبلتُ، واشتريت الكثير من عدة الرسم والأوراق الملونة وفرشت الطابق الأول من المركب بها لتكون ورشة لعب وتلوين للأطفال.
قضيتُ ساعاتٍ جميلة، أفضل التعامل مع الأطفال على البالغين، خيالهم يحاكي خيالي. بعد فترة جاءني أحد الأطفال يبكي ويشكو من طفل آخر اعتدى عليه.
ذهبت إلى الطفل البغيض كان عمره ثمان سنوات، فأخذت أعاتبه وأنصحه، فركلني في قدمي، كان شعورًا مؤلمًا للغاية! فقدت توازني. أخذت الطفل وأمسكته من قميصه، وخرجت به إلى ظهر القارب، ومددت يدي خارج المركب، هل تحب أن ألقيك في البحر؟ حتى تتعلم الأدب؟
استفقت على صراخ والده وأمه من الطابق الثاني، أعدته إلى المركب وانطويت على نفسي إلى أن رسا المركب، اتصلت بصديق لي، وقلت له أريد أن أشرب، قابلني عند محطة الترام. جاء صديقي ومعه السجائر، أخذت واحدة، قال لي: ألم تقلع؟ وهو يناولني. لم أرد عليه، أخذت نفسًا عميقًا، وشعرتُ بأني في أسعد لحظات حياتي. ثم بعد ثوانٍ قليلة شعرت بانخفاض حاد في النشوة سقطت معه على الرصيف. بقيت في شعور يشبه شعور الغريق تحت الماء، لا تصلني الأصوات من حولي إلا كغمغمات غير مفهومة. لم أدرِ كم بقيت على تلك الحال وصديقي يحاول أن يقيمني. استفقت على أذان المغرب، قمت كالمسحور أمشي نحو المسجد، سمعتُ صديقي من خلفي يناديني إلى أين؟
قلتُ له أشعر أن نهايتي قد اقتربت، لتكن نهايتي في المسجد!
توضأت ودخلت إلى المسجد، كبرت وشرعت في الفاتحة، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ثم توقفت، شاشة سوداء، لا أدري ما الذي يأتي بعد هذه الآية. أعدت السورة من البداية.. وتوقفت عند مالك يوم الدين مرة أخرى.. نسيت كل القرآن.. شعرتُ أن الله حجبني، وأنه يقول لي: لقد اغتررت بلطفي، تتوب وتعود كأن الأمر إليك.. سأحجبك حتى عن أبسط ما تظن أنك قادرٌ عليه.. شعرتُ برعب رهيب.. رأيت الإمام يجلس في المحراب.. زحفتُ إليه على بطني.. وقلت وأنا أمدُّ يدي إليه وبكل ما أعرفه من التركيّة “أيها الإمام، ساعدني أريد أن أصلي..” نظر إليّ نظرة لن أنساها، كأني كومة قمامة.. جاء صديقي وأخرجني من المسجد وعدنا إلى البيت…” صمت وأخذ رشفة من كوب الشاي الذي أمامه.
“ثم ماذا؟” سألته وقد أسرتني تفاصيل القصة.
“علمتُ أني لا ينبغي أن ألعب مرة أخرى في مسألة التوبة، لقد قيل لي إن الأمر ليس إليك، وأنا المتحكم لستَ أنتَ، وبالتالي صرت أخاف من نقض أي عهد معه!”.
وماذا قررت؟
“أن أتدرج، حتى تخفّ عليّ أعراض الانسحاب، ولا أتحمس في القطع مرة واحدة فأرتد وأنتكس، وأخذت أقلص حتى وصلت إلى مرتين في الأسبوع”.
كانت سياسة التدرّج التي انتهى إليها معتز،في مقاربته لعودته إلى التديّن، أقل حماسة من الخلاصة التي انتهت إليها فاطمة.
المليونيرة تبحث عن معنى، فاطمة، سيدة أعمال، 39 عامًا
“أصبح في رصيدي 30 مليون دولار!” قالتها فاطمة على الهاتف بنبرة من يخبر عن الوقت لا من يبشرك بنجاح باهر. “لقد قلّت حماستي لعالم الأعمال. ما أبحثُ عنه الآن وأكلمك لتساعدني فيه، هو كيف يعيش الإنسان لمعنى، لقد غير السابع من أكتوبر حياتي!”.
في الخامس من أبريل/نيسان 2024، بينا كنت مستلقيًا بعد يوم صوم طويل، أترقّبُ أذان المغرب وأطالع تفسير ابن عطية “المحرر الوجيز” شعرت باهتزاز هاتفي بجانبي، نظرت فإذا برقم أمريكي، رفعتُ الهاتف إلى أذني فسمعت صوت فاطمة وهي صديقة خليجيّة تقيم في الولايات المتحدة، انقطع تواصلي معها منذ أربع سنوات. بعد السلام والتحايا، قالت بنبرة جادة: هل تذكر قصتك مع أبي هاني. “نعم” أجبتها باستغراب. “أظن ما قاله قريبًا من الحقيقة. ولقد قررت أن أتوقف عن السعي لجمع المال، ما حصلت عليه يكفيني بقية حياتي”. قالت ذلك بصوت من وصل إلى قرار بعد تفكير طويل.
في شتاء 2019، كنت في مجلس سمر عند أحد شيوخ العلم والدعوة، على الأريكة المقابلة لمجلسي، يتربع رجل في وسط العقد السابع من عمره، يلبس ثوبًا سعوديًّا شتويًّا، ويعتمر قبعة شيشانية، وحين تفرّق المجلس العامر بالأحاديث الثنائية، رفعت صوتي مخاطبًا إياه وهو يتربع في صدر المجلس “أخبرنا يا أبا هاني، متى تتحول الثروة بين الأثرياء إلى فرق أرصدة في البنوك، وتتقارب معيشتهم؟” توجهت إليّ أنظار الجالسين فجأة، ورأيت نظرة استفهام تعلو محيا أبي هاني، فأضفت للتوضيح “أعني أن لاستهلاك الإنسان في الطعام والشراب والملبس والمسكن سقفًا محدودًا، فمتى تصبح معيشة الأثرياء قريبًا من قريب؟ سكنَ المجلس وانقطع الصوت، ورمى الجميع بأنظارهم إلى أبي هاني الذي تبلغ قيمة أوقافه في مكة المكرمة فقط مليار ريال. حاول أبو هاني تجنّب الإجابة، ولكن إصرار صاحب المجلس الذي أعجبه السؤال، حمله على أن يقول باقتضاب “أظن بعد أول 30 مليون دولار سيكون نمط حياتك قريبًا من حياة من لديه مليار دولار!”.
انتقلت فاطمة من الخليج إلى الولايات المتحدة في عام 2012، في منحة ابتعاث، لدراسة ماجستير في إدارة الأعمال، كان حديثها ينصبُّ دائمًا على الاستقلال المادي وتكوين ثروة تمكنها من توسيع خياراتها في الحياة. التحقت لا حقًا بأحد الصناديق الاستثمارية، وأسست مكتبًا للتنسيق بين الشركات الأميركية ورأس المال الخليجي. كانت هذه أخبارها قبل انقطاعها. اليوم دخلت فاطمة إلى الأربعين صحبة ثروة تكفيها وتكفي جيلين من سلالتها، لتنصرف بحثًا عن المعنى. كان السابع من أكتوبر حدثًا فارقًا في حياتها، عادت فاطمة التي طالما رأت نفسها مواطنة عالمية، إلى رؤية العالم بصورة مغايرة. تعيش اليوم فاطمة مع زوجها الأميركي الذي أسلم حديثًا رحلة لاستكشاف موروثها الديني في عينَي زوجها الجديد الذي يدخل إلى هذا العالم أول مرة.
الجنديّ المهدور، نديم، طالب علوم سياسية، 28 عامًا.
“هل كان يشغلك سؤال الإيمان من قبل؟” سألت نديم طالب العلوم السياسيّة، ونحن نرقى درج بناية قديمة في حي الفاتح في إسطنبول.
“كنت بعيدا، لم يكن وجود الله أو عدمه يعني لي شيئا، ما الذي سأستفيده من وجوده؟” قال لي نديم وهو يخلع سترته ويعلقها على مشجب بجوار الباب، بعد أن دخلنا إلى شقّته العتيقة التي يكسوها الخشب.
“لكنكَ من أسرة ملتزمة” استدركتُ على جوابه، وأنا أخلع حذائي لدى الباب.
“كان الإجبار على الفروض الدينية قد ولّد لديّ رغبة عكسيّة بالتحرر من الدين، ولكني كنتُ أجامل والدي في أداء بعض الفروض معه”.
“وإلى متى دامت هذه المجاملات؟” سألته بعد أن ألقيتُ بجسدي على الأريكة الممتدة في زاوية المجلس.
“في 2015 صعد خطيب حيّنا المنبرَ، وبدأ خطبته بمهاجمة افتتاح معهد لتعليم رقص الباليه في مدينتنا، واصفًا من يرتاده بالعاهرات الداعرات، كان بعض زميلاتي في المدرسة يرتدنه، وشعرت بغضب شديد لدرجة أني غادرت المسجد ولم أنتظر الصلاة. بعد شهور، ألقت السلطات القبض على الخطيب في جريمة أخلاقية، حينها جئت لوالدي، وقلت له: لا تتحدث معي بعدها عن مسألة الصلاة، لن أصلي بعد اليوم!”.
دخل نديم المطبخ وأحضر معه كوبين من الشاي في كأسين غير معدين لتناول الشاي، ووضع أحدهما أمامي. حركة كهذه قد تنشئ خلافًا حول أصول الضيافة لو كانت سيدة البيت حاضرة، ولكنه كان قد انفصل عنها منذ أشهر قليلة. نظر إلى هاتفي الذي أخرجته ووضعته على وضع التسجيل وقال مستغرِبًا: “هل ستسجل كلامي؟”.
“بالتأكيد، لا يمكن أن يفوتني شيء من كلامك حين أفرّغ المقابلة، لكن تأكد أن أحدًا لن يستمع إلى هذا التسجيل سواي، وبعد أن أفرّغ التسجيل في نص مكتوب سيختفي التسجيل من الوجود”. بدا غير مطمئن؛ فأضفتُ “اسمع يا سيدي، لو أحببت أن تضع اسمًا مستعارًا في الحوار فهذا ممكن أيضًا، المهم أن تحكي قصتك كما هي!”، وحين سمع فكرة الاسم المستعار، تلاشى توتره، فقال “هذه فكرة مناسبة، ضع اسمًا مستعارًا إذن”.
ألقى بنفسه على الأريكة المقابلة لمجلسي، وبدأ يتحدث “كنت قارئًا نهمًا، لم يناسبني جوّ الأسر الإخوانية التي أدرجني فيها والدي، بعد تجاوزي للعشرين، تعرفت على كتابات القوميين العرب، بدا لي أني وجدت ما كنت أبحث عنه، لا بد من فهم تاريخنا المعاصر، ومسألة الدولة والفلسفة وعلوم الاجتماع، ليتغيّر وضعنا، بدت لي كتابات الإسلاميين رجعية، أو لعصر غير عصري، ما كان يشغلني كيف يمكن أن نتحرر من إسرائيل وتصبح لدينا دولة عربية قوية، رافقتُ شباب اليسار وبدأت ظروفي الماديّة تتحسن، من العمل عن بعد، كثُر المال في يدي فتوسّعت في الشراب، والتجارب الجنسية، لقد كان ضلالي سلوكيًّا”.
لم يكن ضلالًا عقديًّا؟ كنت تبدو ليَ مؤمنًا على الأقل على مستوى الكليات! قلت له، وأنا أرتشف من الشاي، الذي لم يلبث أن برد بسبب الجو، وضعف التدفئة.
“كنت أستمع إلى كلامكم حين ألتقي بك وبأصدقائك، لكني لم أكن مهتمًا، لم يكن لي موقف فلسفي من وجود الله والدين، كنت غير مبالٍ”.
“إذن كنتَ تحقق لذائذك الدنيوية بتلك السلوكيات، وتعالج لذائذك الروحية بمسائل معرفية تتعلق بما يطرحه اليسار والقوميون؟” قلتُ محاولًا تلخيص فكرته.
“بالضبط، سؤال الدولة والتحول الديمقراطي، تلك هي الأسئلة التي تشغلني، والأجوبة هناك وليست عند الإسلاميين، ما المهم في تربية شباب مؤمن؟ المهم إنجاز نظام سياسي يعالج مشكلاتنا! وجدتُ الأجوبة عند بعض المفكرين العرب”.
هل طرأ عليك تغيير حين وصلت إلى تركيا؟
“بدت لي هويتي في صورة أوضح، لا تعرف نفسك إلا بالضد؛ في تركيا عرفت أني عربي، وحين تزوجت من امرأة غير متدينة، أدركت أني مسلم” قال هذا وهو يحك عارضه الذي لم يحلقه منذ أشهر.
لاحظت أنك نشطت في السنة الماضية في الكتابة الأكاديمية، ونشرت أبحاثًا في الدراسات العسكريّة، والتحول الديمقراطي في مجلات علميّة محكّمة. ومع هذا الإنجاز، لاحظت انطواءك عنا؛ ذلك الشاب الذي تعرفت عليه أول وصوله إلى إسطنبول لم يعد هو، صار مزاجك غائمًا معظم الوقت، لم تعد تشاركنا قراءاتك أو خلاصاتك، بدا لي أنك فقدتَ حماستك الثقافيّة، ما الذي جرى لك في السنة الأخيرة؟
“لقد عاد عليّ سؤال السياسة بالاكتئاب، كل ما يقوله لنا مفكرونا في تفسير الواقع وإيجاد حلول لا أثر له، وكأن خلاصاتهم معطوبة. وضع الدول العربية وصل إلى حالة مأساوية؛ سوريا واليمن والعراق أصبحت حمامات دم مفتوحة، وغدت إسرائيل شيئًا طبيعيا في الوطن العربي، وانتقل هذا التطبيع إلى مزاج المثقفين من أصحابنا، لم يعد هناك تقزز من مسألة التطبيع، كان التقزز يحضر عندهم حين يُذكر الإسلاميون أو حماس! لجأت إلى الحشيش كان يشتت ذهني بطريقة مريحة” قال هذا ونظراته مشتتة، ثم نظر إليّ وتسمّرت عيناه على عينيّ وأكمل:
“إلى أين أنتمي؟ سألتُ نفسي، إلى مشروع فكري لا يستطيع أن يؤثر في الواقع ولا تبدو له جدوى. كنت أرى نفسي جنديًّا، ليس هناك مكان لهذا الجندي، المشروع القومي وأدبيات التحول الديمقراطي ليس لهما أفق!”.
“أليست هذه أفكار بَعديّة؟” قاطعتُهُ، وأكملت حين رأيت علامة استفهام على وجهه “أقصد لعل الحدَثَ أثّر فيك لدرجة أنك أعدت قراءة مشاعرك بهذه الطريقة، ولم تكن كذلك في الحقيقة وقتها” بدت ملامحه تتغير كمن استفزّه السؤال، أمسك هاتفه، وقال سأريك شيئًا، أنا هنا لا أجيد نسج القصص. وإنما أحكي لك مشاعري كما كانت، اقرأ هذا المنشور الذي نشرته في صفحتي، وانظر إلى التاريخ:
28 سبتمبر 2023، “كلنا محبطون، لا يوجد أي مشروع عربي نضالي يمكن أن يجندنا للعمل فيه، كلنا جنود خارج الخدمة.!”.
أعدتُ له الهاتف، فقال وهو يمد يده إليّ:
“كأن الذي قام بالسابع من أكتوبر شعر بأسئلتنا، وحاجتنا إلى مشروع”.
كيف تلقيت الحدث؟
أيقظتني زوجتي “قوم شوف شو صاير بغزة”.
“حين رأيت العلم مركوزًا فوق الدبابة الإسرائيلية شعرت بقطيعة مع كل تجربتي، شعرت بأني ابن لحماس ولجهاز الدعوة، وسقط الفاصل الليبرالي الذي عشته لثمان سنوات، لقد اتصل السابع من أكتوبر بـ2015 ورجعت إلى حارتي ووالدي والأسر التابعة للحركة الإسلامية”.
بدأ نديم يتحدث بطرب، وكأنه يتذكر ذكرى سعيدة “كان المشهد موصولا بالزمن الأول، الرجل يسير معرفًا نفسه كمسلم، وبدون هويّات فرعيّة تعبت منها ألسنتنا، اتصل السابع في مخيلتي ببدر وملاحم الإسلام. كنت أرفض هذه المقارنات، نحن أبناء هذا العصر، كنت أسخر من والدي حين يضرب لي أمثلة ببدر وأحد وأقول له تلك كانت “شوية” سيوف ورماح نحن أبناء القرن العشرين والواحد والعشرين، كم أدركت صواب والدي. كنت أصدق مقولة نابليون: الله مع صاحب المدفع الأكبر، لكني الآن أصدق القرآن {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.
ما أول تغيّر طرأ في سلوكك وقتها؟
“كنت أكفر وأشتم الذات الإلهية، خرس لساني عن هذا بعد السابع، انعقد لساني عن الكفريات، بعد أن رأيت الملائكة تقاتل، ورأيت قدرة الله!”.
رأيتَ الملائكة تقاتل؟ سألته باستغراب.
“ذلك التوفيق لا بد أن يكون بتدخل إلهي، لقد آمنت بالمعجزات لأني أعرف البنية العسكرية التي تحيط بالقطاع، لم يكن ذلك عملًا بشريًّا خالصًا”.
“في يوم 18 أكتوبر صليتُ أول صلاة منذ 2015. في مسجد قديم في مدينة ماردين صليت الظهر، وفتحت المصحف، وتشهدت، بدأت القراءة من أول المصحف، واصطدمتُ بآية في الصفحة الثانية، وأخذت أبكي، لقد كشفت لي تلك الآية سنواتي الماضية”.
ما هي هذه الآية؟ سألتُه وأنا أهذّ في سري أول ورقتين من المصحف محاولًا أن أحزر تلك الآية.
“لحظة” مد يده ليفتح هاتفه ويبحث في تطبيق المصحف، بعد ثوانٍ قال: “وجدتها! {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} لقد كنا نصدّر للمجتمع أننا نملك الأجوبة من قيم الليبرالية، كنا ندعي ما نعمله إصلاحًا، وهو إفساد!”، واغرورقت عيناه بالدموع مرة ثانية.
“هذه آياتي، كنت أكررها وأبكي، قلبي توقف عن نبضات التوتر، شعرت بالسكينة، ختمت الختمة الأولى، والآن قطعت الكحول، لم تفتني صلاة، وصارت قدمي تحملني للمساجد. ما عدا صلاة الجمعة، ثمة شيء يمنعني من حضورها، للرواسب القديمة”.
بمَ تشعر حين تقرأ القرآن؟
“أشعر بعلو في نفسي”.
لكن هذا الانتشاء لم يلبث أن زال بتغيّر المشهد. صار المشهد أشد قتامة بحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل، هل اهتزّ إيمانك تحت كثافة الدم؟
“لا” أجاب بحِدَّة.
لم يرد إليك سؤال الشر ولماذا يفعل الله بأهل غزة كل هذا؟
“مسألة الشر لم تعد لاهوتية عندي، بل صارت سياسية، فأنا أحمّل الوحشية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. أنت في محيط فاسد، ما حصل في السابع هو رسالة إلهية للأمة، لقد أريتكم آية وبقي دوركم ليس دوري. لقد سئمت من مقاربة العلمانيين لهذه القضايا!
لماذا تكون الديمقراطية مسؤولية الأمة كما يقولون لنا، أما مسؤولية التحرر فتكون مسؤولية غيبية؟؟!”
إقطاعيّة غزيّة كانت تبغض حماس، ديمة، مسعفة طوارئ، 32 عامًا
حين تعمل صحفيًّا جوّالًا، ينبغي أن تُهيِّئ نفسك لمواقف غريبة، مثل أن يلهث كلبٌ ضخم عند أذنك ويَهمّ بلعق عنقك، وأنت صابرٌ ومحتسب في سبيل إجراء مقابلة.
اتصلت ديمة لتخبرني أنها لن تستطيع أن تصل إلى بيتها على موعدنا في الثامنة مساء، لأنها لا تزال في منطقة بعيدة، وتحتاج إلى أن تركب الباص، الذي سيأخذ منها ساعة على أقل تقدير.
“يمكنني أن أقلّك بسيارتي، أنا قريب من الحيّ الذي أنت فيه”. لم أكن، لكني كنت حريصًا على إجراء المقابلة قبل سفري في اليوم التالي.
“لكن شيكو بصحبتي، هل تمانع؟”
“أبدًا مرحبا بك وبصديقك”.
بعد ضحكة عالية قالت “ليس صديقي، شيكو اسم كلبي”.
’قبيحٌ قول لا بعد نعم!’ رنَّ بيت المثقّب العبدي في أذني.
“حسنا لا بأس” قلت وقد أُسقط في يدي.
“شكرًا لك، ستكون مقابلة عظيمة” قالت لي ديمة بصوت يضجّ بالحياة، لتهوّن عليّ صعوبة أول اقتراب من كلب.
بعد نصف ساعة من القيادة رفقة شيكو الذي “أحبني” حسب تعبير ديمة، وكان حبًّا من طرف واحد بكل تأكيد.. وصلنا إلى طرق حيّها الضيقة. أوقفنا السيارة في أول الشارع ودخلنا مشيًا على الأقدام، انطلق شيكو أمامنا، ليدلّنا على البيت الذي يعرف مكانه جيّدًا.
في الطابق الثاني حيثُ تسكن فتحت الباب فانبعثت رائحة عطريّة طيّبة تخالطها رائحة الرطوبة التي لا تسلم منها البنايات القديمة. شقة صغيرة تتكون من غرفة نوم وصالة تحتوي على مطبخ صغير، أشياء ديمة في كل مكان، مقتنياتها تفيض عن قدرة شقتها في الاستيعاب. لكنها شقة نسائيّة فالفوضى فيها مرتبّة بطريقة ما.
“تفضّل هنا” قالت ديمة وهي تنفض لي الأريكة من بقايا مجلس سابق.
“سمعتُ أنكِ غزيّة وتكرهين حماس؟” قلتُ لها وأنا أخذ مجلسي، وأضع جهازي على وضع التسجيل.
“لستُ أنا فقط، كل طبقتي تكره حماس، لكن لم أعد أكرهها، بعد السابع من أكتوبر!”.
“طبقتك؟”
“ملاك الأراضي، الطبقة البورجوازية، أنا من عائلة ثريّة في دير البلح، وكثير من الأغنياء ليسوا على وفاق مع فكرة المقاومة، قديمًا، وحتى اليوم!” قالت ديمة وهي تبحث عن شيء في دواليب مطبخها. تحبُّ “الميرامية في الشاي؟” سألتني وهي تخرج كيسًا كبيرًا من أحد الأدراج.
“جدًّا” أجبتها. “أخبريني عن عائلتك الإقطاعيّة؟” سألتها مستفزًا.
“جدي لأمي يملك مساحات شاسعة من الأراضي”
هذه عائلة والدتك، ماذا عن عائلة والدك؟
“والدي ابنُ عم والدتي، ملّاك الأراضي لا يتزوجون إلا من بعضهم. حفاظًا على الثروة”.
ما قصة كرهك لحماس؟
“قلتُ لك لم أعد أكرههم، كانوا سلطة منع وتشديد، وصاروا أداة للتحرير” أجابتني وهي منشغلة بشيء في هاتفها، عرفتُ لاحقًا أنها كانت تطلب طعامًا. وضعت الهاتف، وبدا أنها تجمع تركيزها للمقابلة.
“علاقة الكره نمت معي منذ طفولتي، درستُ أولًا في مدرسة راهبات، كانت الأسر الميسورة ترسل أبناءها إليها. ولكن لأني كنتُ أسكن في دير البلح، كنت أضطر للمرور بحواجز أمنية وضعتها إسرائيل في طريقي للمدرسة كل يوم، بعد فترة، رأت والدتي أن تسجلني في مدرسة قريبة، كانت مدرسة الصلاح الإسلامية”.
كان اختيار والدتك لمدرسة إسلامية بدافع الأيديولوجيا؟
“لا، أظن أنه كان بدافع لوجستي لبُعد المدرسة، وخوفًا عليّ من حواجز الاحتلال. لا أدري حقًّا ماذا كان دافعها في الأساس، الآن صرتُ أعتقد أنها ربما لما رأت تمردي، أرادتني أن أنشأ في بيئة إسلاميّة، لست متأكدة، لكني أشعر بهذا”.
كيف كان جوّ المدرسة الجديدة؟
“سيئة للغاية” أجابت بغضب وكأنها تذكر ذكرى مزعجة.
“كانت طريقة المعلمات فظة وقاسية، ولا بد من الحجاب حتى ونحن في الابتدائي، حجبوني وأنا في الصف الخامس. كان خطابهم تنفيريًّا.
كانوا يخبروني بأني سأتعلق من شعري لأنه يظهر من تحت الحجاب، وسيصب في أذني النار لأني أسمع الموسيقى!”.
لم تكن عائلتك محجبة؟
“لم تكن النساء في عائلتي يرتدين الحجاب، وكان الرجال يتعاطون الشراب في البيت، والدتي فقط كانت محجبة، وكانت تدعو لنا ولكنها لم تأمرنا قط بالصلاة أو الحجاب!”.
“هذا وجه لا يعرفه الناس عن غزة”، قلت متعجبًا.
“نمط ملاك الأراضي، والأثرياء مختلف عن بقية السكان، حياتهم تدور حول التعليم والتنزّه والملابس والسفر”.
السفر؟ أليس الوضع في غزة معقدًا بهذا الخصوص؟
“بعلاقاتهم ورُشاهم يستطيعون الخروج إلى مصر” أجابت، ثم أردفت كمن يريد أن يسجل اعترافًا “نشأت في طبقة كان علينا فيها أن نأكل بطريقة معينة ونلبس بطريقة معيّنة، لم أحبب هذا النمط قط، نفسي تنفر من الترف وقيوده!”.
لمَ؟ يبدو مريحا!
“بِدّي أصير فلاحة، أحب نمطهم وطريقة حياتهم، لديّ أثواب تقليديّة أخذتها من أمي، عمرها فوق الستين عامًا!”.
هل أثرت ثوريّتك في علاقتك بأهلك؟
“كانت علاقتي مع والدتي تتوتّر وتهدأ، أحبُّ والدتي جدا”.
ووالدك؟
“لم يكن حاضرًا في حياتي كما ينبغي، ما أذكره عنه هو تحضيره الدائم لحقيبة السفر، لا أظن أني لامسته إلا بعد وفاته حينما عانقت جثمانه!”.
وإخوتك؟
“لديّ أخوان كبيران فوق الخمسين، أحدهما في روسيا، والآخر في أميركا، لم أرهما، وليس بيننا تواصل”.
ولماذا خرجت من غزة؟
“أنهيت كل شيء هناك، أبحث عن شيء جديد” بعد سكتة قصيرة، “تزوجت مرتين وانفصلت، أظن أني جئت إلى إسطنبول هروبًا لا بحثا عن الدراسة” قالت هذا وكأنها تخاطب نفسها، لم أُرِد أن أنتقل من عمل الصحفي إلى الطبيب النفسي بفحص هذه الإجابة، فسألتها:
ماذا درست؟
“درست في كلية التجارة، وأخذت دورات في الإسعاف الطبي في غزة، ومارسته ميدانيًّا، وأخذت جائزة أفضل مسعفة في فلسطين في سنة من السنوات، والآن أدرس الإسعاف والطوارئ”.
من الأرستقراطية وكلية التجارة، إلى الإسعاف والطوارئ، ما هذه القفزة؟!
“هذا أقرب إلى شخصيّتي، تخفيف الألم يشعرك بالجدوى، في العدوان الإسرائيلي 2014 كنت في الميدان، أسعف المصابين” صرفت نظرتها عنّي فجأة وحدّقت في الحائط، وقالت وعيناها تلمع في بركة دموع لم تسقط بعد “رائحة الجثث المشويّة لا تفارق ذاكرتي”.
دقَّ الجرس، ونبحَ شيكو، “وصل الطعام” قالت وهي تتجه إلى الباب وتعود بصناديق من الفطائر التركيّة.
“أين هذا البستان؟” قلت وأنا أشير إلى صورة معلقة على الحائط الممتلئ بقصاصات ورق تحتوي على عبارات تحفيزية ومقاطع من أبيات وأغانٍ شعبيّة، محاولًا أن أصرف الحديث عن الطعام كما يفعل أي ضيف يشعر بحرج تكلّف صاحب الدار له، وهو طامع في العشاء.
“هذا بيت عمّتي في دير البلح، كل بيوتنا تحتوي على أشجار البرتقال والزيتون والنخيل!” قالت وهي تفتح صناديق الطعام.
“أين كنتِ يوم السابع من أكتوبر؟” قلتُ وأنا أقضم لقمة صغيرة على غير عادتي من الفطيرة الساخنة.
“كنت مع صديق لديه اختبار سياقة جار ومجرور”.
تقصدين سياقة شاحنة؟ تساءلت وقد انتعشت بتعريبها البديع لـ’A towed car’
“نعم، اتصل بي أصدقائي ليخبروني: حماس دخلت المستوطنات. شعرت بنشوة عظيمة، لقد نسي الفلسطينيون قضية التحرير وشككتُ أنا يوما في جدوى المقاومة، وصار الخلاف بين الفصائل حول قضايا إداريّة، ذلك اليوم شعرنا بتصحيح المسار، اتصلت مباشرة على مديري في الهلال الأحمر أخبرته برغبتي في النزول، وفي التاسع من أكتوبر كنت في المعديّة التابعة لمحافظة البحيرة المصرية، في طريقي إلى رفح، حين اتصل بي مديري وقال لي أسوأ خبر، لقد قصفوا المعبر ولا يمكنك الدخول!”.
أدخليني في عقلك، فيمَ كنتِ تفكرين وقتها؟
“أول خاطر سيطر عليّ، لماذا المقاومون يأتون من عائلات معينة، لبسهم البسيط، أشكالهم، حفاظ للقرآن، لا يشبهون غيرهم. أخذت أتابع أسماء الشهداء، أبحث عن صفحاتهم، أتأمل في طريقة نعي أهلهم لهم وتعاملهم مع الفقد؛ لغتهم، كانت لغة غريبة بالنسبة لي. غريبة عن بيئتي. كانت بيئتي مرتبكة جدًّا وحانقة على المقاومة، وليس لديها كاتلوج للتعامل مع البلاء. وقتها رأيت صورة من يتوضأ وسط القصف والدمار ورائحة الموت، ليؤدي فرضه. ’’بِدُّه يعطي حق ربنا في هذا الوقت!’’ تبدو الصورة واضحة له، أن هذا قدر وأن موقفه محدد”.
“أخذتني صديقتي إلى مجلس تدارس للقرآن، لم أستوعب حينها كيف أخذتني قدمي إلى ذلك المكان، ربما كان قبولي بدافع الملل، حين دخلتُ البيت كان المجلس مليئًا بالشباب والبنات، قلتُ لصديقتي اطلبي منهم ثياب الصلاة، ربما يزعجهم تبرجي، رحبت بي سيدة المنزل بودٍّ مفرط، ولم تبدِ أي انزعاج من ملابسي، جلسنا وبدأ المجلس، ووزعت المصاحف، قرأنا آيات من سورة البقرة، جاء دوري في القراءة فأخطأت كثيرا وكان تصويبهم لي في غاية التلطف والعطف. ثم علّق زوج السيدة التي استقبلتني على الآيات، وأخذ الحديث يدور بين أهل المجلس. حانت الصلاة، فناولتني السيدة ثوب الصلاة، وتقدم زوجها يصلي بنا، كان يرتل سورة الزلزلة بطريقة ساحرة، يتوقف عند كل آية ويعيدها بصوتٍ شجيّ، تزلزل كياني، انفلتّ من الصلاة وقد رأيتُ صورة أخرى من الدين. كنت أظن أني لا أصلح إلا للنار، وعشت حياتي على هذا الأساس. حين انتهى مجلس التدارس تحول الاجتماع إلى أحاديث بهيجة، رأيتُ وجهًا جديدًا من التديّن، وأدمنتُ على المجلس بعدها، حتى حين تتغيبُ صديقتي، أحضر بمفردي..”. كانت ديمة قد فتحت هاتفها تقرأ لي نصَّا كتبته يحكي تجربتها في العودة إلى الدين.
“عدت إلى الصلاة، وإلى قراءة القرآن، كنت أقرأ أمس جزء عمَّ شيء مهول أشعر به، كأنه يكلمني”.
لم يرتدّ شعور الإيمان لديكِ مع كثافة المأساة الإنسانية والإجرام الصهيوني؟
“لا، لأن طريق التضحية هو الطريق الذي سيأخذنا إلى النهاية. نحن موعودون بالنصر لا محالة!”.
هل كنتِ مؤمنة بهذا من قبل؟
“لا، لكنه أصبح يقينًا بعد أكتوبر!”.
أي شعور يقودك في علاقتك الآن مع الله، الخوف أم الحب؟
“لا أدري، كلامه يخيفني، هو مش واحد يلعب معي في الشارع، هو كبير، كبير جدًّا!”.
ديمة أشكرك، تأخر الوقت، شكرًا على كرم الضيافة، هل تريدين أن تختمي بشيء؟
“أريد أن أكون هناك حين يجيء الطوفان القادم”.
الصلاة علاج لـADHD، سلمى، طالبة فنون، 25 عامًا
أعاني من إدمان على الهاتف كثلثي جيل “زد Z”، ولتخفيف الإدمان، قيّدتُ الإشعارات، كل تطبيقات التواصل في هاتفي لا تتطفل على شاشتي، ولا أعرف ما فيها إلا اختيارًا، حين أفتحها. فتحت تطبيق إنستغرام يوم 30 أكتوبر وجدت رسالتين محذوفتين من سلمى، وهي صديقة فلسطينية من عرب 48.
30 أكتوبر:
“أرسلتِ شيئًا ثم حذفته؟ للتو فتحت التطبيق” كتبتُ لها.
“صحيح!” جاء الرد بعد دقائق.
“أثرتِ فضولي، هل يمكنك إعادة إرساله؟”.
جاء صوتها الذي يتردد بين الفصحى المصقولة، وعاميّة فلسطينيّة عذبة “مرحبًا مولانا، كان شيئًا يتعلق بموضوع التديّن الذي ناقشناه سابقًا، سجلتُ، ثم فكرتُ وقلت قبل المشاركة عليّ أن أفهم ما حدث لي جيدًا قبل أن أشاركه الآخرين فمحوته!”. لم أكمل استماعي للتسجيل الأول حتى أرسلت تسجيلًا ثانيًا “حسنًا سأخبرك، لقد صليت أول صلاة في حياتي، أنا لا أحفظ الفاتحة! لكني صليت.. فتحت اليوتيوب وقلّدت ما رأيت! لو تمنيت شعورًا يعم الناس ليعيشوا في سلام فسيكون شعوري بعد أول صلاة!”.
بعد أشهر من رسالتها جلسنا في المقهى القريب من نُزُلها في إسطنبول لنكمل الحوار..
“كعربية من الداخل الفلسطيني، لم نتربَّ على الإسلام!” قالت سلمى القادمة من فلسطين لزيارة إسطنبول قبل شهرين، والتي تفكر في خطر العودة إلى أهلها في حيفا مع السعار الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى الدعوى المرفوعة ضدها بسبب مشاركاتها في مواقع التواصل.
“لا يمكننا إجراء حوارنا هنا، لا أكاد أسمعك!” قلت لسلمى رافعًا صوتي، بعد أن جلسنا في المقهى الذي اقترحته، “الموسيقى عالية، وضحكات الناس مزعجة!”.
انتقلنا إلى حديقة هادئة بالقرب من الحي الذي تسكنه، جلست سلمى التي تلبس شالًا من الباشمينا، حولته إلى رداء بطريقة ما. وضعتُ مذكرتي وهاتفي على وضع التسجيل، بدأت السماء تمطر وشلًا خفيفًا، من حسن حظنا أن الطاولة مسقوفة. أخبريني، كيف يمكن أن يرى أهل الداخل السابع من أكتوبر؟
“في الداخل، تراكمات من الخوف، نحن الفلسطينيون الوحيدون الذين بقوا بعد النكبة، أجدادنا عاشوا مرارة المجازر وبقوا وسط الجثث، وعاشوا تحت الحكم العسكري، الذي يمنعك من أن ترفعَ رأسك. في كل مظاهرة يقف لنا الكبار على الأبواب، وقد فقدوا الأمل من جدوى التظاهر، لو كنا نعرف أن ثمة فائدة لخرجنا معكم، يقولون لنا في كل مرة!
في أوسلو صار الحديث عن الضفة وغزة، وانحكى لنا [نحن عرب الداخل] دبروا حالكم. كنا نرى إسرائيل قدرًا أبديًّا، فجاء الطوفان وقال لنا: ’طولوا بالكم’. لأول مرة رأينا إمكان التحرر!”.
هل شعر أهلك بالخوف؟
“في الأشهر الأولى منعت العوائل النساء من الخروج من البيوت ومن القرى، خوفا من الانتقام”.
وأنتِ بمَ شعرتِ في السابع؟
“أول سؤال خطر بذهني: قادرون نعمل ’هيك’؟ ما حفظناه سابقًا من أدبيات النضال، رأيناه ’لن أصافح بل سأصفع’ يمكننا أن نصفع ونوجع! لقد كنا نظن أن هذا الغبن والظلم سرمدي، رأينا وجهًا من أوجه النهاية، صرنا نستطيع أن نذيقهم من كأسهم. كثيرا ما حكوا عن الخطر الوجودي، لأول مرة بدت إسرائيل تحارب لوجودها.
رأيتُ الشباب داخلين على المستوطنات، رافعين بنادقهم، السلاح المشروع في هذه الشوارع هو سلاحنا لا سلاحهم. أربكني مشهد أحد المقاومين وهو يطلب من مستوطن هويته، قال له: هات هويتك! مشهد لا يحلم به فلسطيني في الضفة الغربية أو في الداخل. هذه جملة لا تقرع سوى آذاننا! لم أكن أظن أن تلفظها أفواه فلسطينية!” كانت سلمى تحكي هذه الحادثة بحماسة من يتحدث عن حلم مستحيل.
هل أنهى السابع فكرة الأسرلة؟ سألتها وأنا أنحي أغراضي من طرف الطاولة بعد أن صار رذاذ الماء يصل إلينا.
“فكرة الأسرلة منتهية منذ أعلنوها دولة يهودية. كنا نقول يمكننا نظريًّا أن نجمع بين عروبتنا والعيش في دولة إسرائيلية. لكن مع قرار تهويد الدولة، لا يمكن لك أن تكون مواطنًا حقيقيا، ولا يوجد أفق للتفاهم، مع السابع أصبح الأمر واضحًا حتى للأعمى ’’يا إحنا يا همّ’’!”
أخرجت سلمى سجائرها النسائية الرفيعة، وأشعلت واحدةً، واستأنفت:
“على مستوى النفسي، كل ما كنت مسلحة به فكريا خذلني، تربية مخيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب يعرّف نفسه كحزب فلسطيني، ويعرف فلسطين بحدودها التاريخية ويدعي أن ثمة طريقًا في المواءمة بين المواطنة الفلسطينية والديمقراطية الليبرالية والقومية العربية. كان من المفروض أن الترسانة الفكرية للحزب تجيبك عن كل ما يحصل. بعد السابع من أكتوبر توقفت هذه العقيدة عن العمل، رأينا الديمقراطيات كيف تعمل، والليبراليين كيف يتحدثون وكيف تعالج الليبرالية هذه المسائل”.
“تعرف يا أبا خالد” قالت وهي تنفث دخانها “أكبر خطأ وقعنا فيه، أننا قدمنا الإسلام على السويّة مع الأيديولوجيات الأخرى، الإسلام أكبر! لم ينقذني أي مفهوم للإله سوى الإله بالمفهوم الإسلامي”.
ماذا تعنين؟
“بعد الأحداث دخلت في حالة تشبه الاكتئاب؛ وكنت بين خيار الانتحار، أو أن أصبح أسوأ شخص في العالم” [أي بعدم اكتراثها لما يحصل لأهلها] “الإله بالمعنى الإسلامي، هو الذي منحني الراحة!”.
“لقد تغيرت قناعاتي؛ أصبحت أعالج الأمور ’بسوفت وير’ مسلم، لا الليبرالية ولا الاشتراكية، دينكم هذا فيه كل شيء لا تستشكل شيئًا إلا ووجدت له جوابا”.
وجدتِ جوابًا لكل استشكال؟
“لحد الآن، مشكلتنا أننا نستشكل أشياء ليست مشكلة!”.
لم تنحصر الدوافع لعودة التدين بين الشباب في المراجعات الفكرية والبحث عن أجوبة فلسفية. حين التقيتُ بمحمد، الذي بدا خجولًا جدًا، كان جوابه موجزًا وبسيطًا وبعيدًا عن أي مراجعة فكريّة. “في السابع، شعرت بالخوف من النهاية، قرأتُ الحادثة كعلامة من علامات الساعة، جعلني الحدث أفكر بكثرة المعاصي التي عندي، لستُ جاهزًا لمقابلته!”. بصوت خفيض، واصل الفتى ذو 23 عامًا “تركت التدخين مباشرة، كنت مدخنًا شرهًا، لا تصدق من يقول لك إنه لا يقدر على الإقلاع عن التدخين، لقد تخلصت منه في يوم! وعدت إلى الصلاة”.
ولكن بعد أشهرٍ اكتشفتَ أنها ليست النهاية؟ فلماذا بقيت؟ سألتُه
“صحيح، بدا لي لاحقًا أن الأمر قد يطول، ولكني ارتحت إلى جوّ الطاعات، هذا النمط من الحياة أصبح يناسبني!”
حسنًا سلمى، حدثيني الآن عن تجربتك مع الصلاة، تسجيلاتك حمستني لمعرفة التفاصيل.
“كانت أول صلاة بالنسبة لي كمن خرج من حريق واحترقت كل ملابسه وجاء أحدهم وغطاني برداء وضعه على كتفيّ. شيء مثل حضن أمك، لا لا، بل شيء أحلى أحلى أحلى” أخذت تكررها وكأنها تستدعي ذكرى سعيدة ثم قالت: “جلست أبكي على سجادة الصلاة، ليس لتقصيري فقط، وإنما لأن هذه الراحة والملجأ الآمن كان قريبًا مني جدًّا ولم أنتبه له قط! أصبح لديّ ملجأ آمن من أزماتي النفسية، ومشاكلي الحياتية. بالصلاة تستغني عن البحث عن فراغ في جدول شخص ما ليسمع مشكلتك” انتهت سيجارتها فلم تلقها على الأرض، وإنما دسّتها في فراغ بين خشبتين في حافة الطاولة.
“لا أخفيك، لم أكن أفهم الغاية من فرض الصلاة وبهذا العدد. كنت أقول لنفسي ما هذا الرب الذي تحتاج أن تصلي له خمس مرات في اليوم، بدت لي كعلاقة مع شخص يعاني من اضطراب شعوري يحتاج منك أن تقول له كل يوم أحبك خمس مرات. الآن عرفت أننا نحن الذين بحاجة لهذا العدد لا هو”، وأضافت وهي تشعل سيجارتها الثانية:
“كنت أعاني من مسألة التنظيم في يومي، أنا مشخصة بـ’اضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط ADHD’ لا أدرك كيف ينتهي اليوم، لكن الصلاة ساعدتني، صار عندي مهام صغيرة في اليوم أوقّتها بين الفروض، صارت أوقات الصلاة مثل ’’الديد لاين’’ اللي يعطوك بالجامعة”.